تحديد الرزنامة في الإستراتيجية الاتـــصــالــــيـة
المقدمة:
يعتبر الاتصال من أبرز العوامل التي أنشأت العلاقات الاجتماعية
بين الأفراد من خلال تنظيم وتنسيق الأعمال والنشاطات بينهم، وفي هذا الإطار تعمل المؤسسات
عن بناء اتصال وتفاعل مع محيطها ومن أجل أن تحقق أهدافها لا بد أن تكون رزنامة لمهامها
الإدارية والاستفادة منها لتحقيق النجاح وعليه سنتناول في بحثنا أهمية تحديد الرزنامة
في الإستراتيجية الاتصالية.
المقدمة:
الفصل الأول: التخطيط الإستراتيجي
المبحث الأول: مفهوم التخطيط الإستراتيجي
المبحث الثاني: خصائص التخطيط الإستراتيجي
المبحث الثالث: أهمية التخطيط الإستراتيجي
المبحث الرابع: أهداف التخطيط الإستراتيجي
المبحث الخامس: مراحل إعداد التخطيط الإستراتيجي
المبحث السادس: فوائد التخطيط الإستراتيجي
الفصل الثاني: تحديد الرزنامة
المبحث الأول: مفهوم الرزنامة
المبحث الثالث: أهداف رزنامة الاتصال
المبحث الرابع: معايير تحديد الرزنامة
المبحث الخامس: أنواع الرزنامة
المبحث السادس: تنفيذ الرزنامة وفق الإستراتيجية:
الخاتمة:
الفصل الأول: التخطيط الإستراتيجي
المبحث الأول: مفهوم التخطيط الإستراتيجي
التخطيط الاستراتيجي: هو عبارة عن تخطيط بعيد المدى ويأخذ
هذا التخطيط في عين الاعتبار جميع المتغيرات الخارجية و الداخلية ويقوم بتحديد جميع
الشرائح و القطاعات المستهدفة إضافة لطرق المنافسة.
يقوم هذا التخطيط بالإجابة على سؤال إلى أين نحن ماضون
آخذا في عين الاعتبار الرؤية المستقبلية للمؤسسة و علاقات التكامل والارتباط بين جميع
جوانب هذه المنظمة إضافة إلى أي الأنشطة المختلفة التي تقوم بها.
يعتبر هذا النوع من التخطيط واحدا من المكونات الأساسية
للإدارة الإستراتيجية و يعتمد على التبصر بوضع المؤسسة مستقبلا ثم العمل على الاستعداد
له.
أيضا يعرف التخطيط الإستراتيجي أنه عملية نظامية توافق
من خلالها إحدى المنظمات ويلتزم بذلك الشركاء الرئيسيون في المنظمة على الأولويات التي
تعتبر ضرورية لتحقيق هدفها وفي نفس الوقت تستجيب للبيئة المحيطة بها. ويرشد التخطيط
الإستراتيجي إلى امتلاك الموارد وتخصيصها باتجاه تحقيق تلك الأولويات.
ويعرف "ماكوين" التخطيط الإستراتيجي بأنه عملية
تخطيط منطقية تمتاز بتأثيراتها السيكولوجية الفعال وفي التأثير على الأفراد داخل تنظيم
معين، من خلال مجموعة من الخطوات المنطقية العقلانية التي تستهدف الارتقاء بهذا النظام.[1]
المبحث الثاني: خصائص التخطيط الإستراتيجي
1.
يتسم بالتكاملية: وذلك لرسمه في خطوات متعارف عليها
وبشكل معتمد.
2.
يتميز بأنه نظام فعال لرسم توجهات المبادرة في المستقبل
وتحديد وجهتها ورسالتها وأهدافها وما تترتب عليها من تصرفات يجب ممارستها لبلوغ
الهدف المرجو تحقيقه.
3.
يمتلك القدرة على تحديد المجالات المستقبلية كما يحدد
العمليات والأنشطة المطلوب ممارستها مستقبلا.
4.
يحدد في محتواها ردود فعل تتماشى مع كل ما ستواجه
المنشأة من نقاط قوة أو ضعف أو تهديدات.
5.
يوصف بأنه أسلوب عمل كامل وفعال وذلك لتوافقه وشموله
لمختلف المستويات و الوحدات الإدارية.
6.
يعد أسلوبا خاصا للكشف عما ستحققه المنشأة من عوائد
مادية و مزايا اجتماعية.
المبحث الثالث: أهمية التخطيط الإستراتيجي
من مميزات التخطيط الاستراتيجي انه يعمل على توضيح الأهداف
العامة للمبادرة، والذي ينتج عنه انبثاق الخطط العديدة في مجال العمل والإدارات والتي
تكون الهدف العام الذي يقوم بحكم جميع القرارات الناتجة، كما يوحد هذا التخطيط هدف
العاملين لتحقيق الأهداف المراد التوصل إليها، وتكمن أهمية هذا التخطيط المغاير للتخطيط
التقليدي فيما يلي:
·
تزويد
المبادرة بالغاية والهدف الذي تسعى لتحقيقه.
·
المساعدة
على تخصيص جميع الموارد المتاحة.
·
تزويد
المسئولين بالية التفكير بشكل عام
·
المساهمة
في زيادة الوعي بين الأعضاء بشان التغيير والإلمام بجميع التهديدات والفرص المحيطة
·
تقديم
منطق سليم في عملية تقييم الموازنات
·
تنظيم
عملية التسلسل في مجمل الجهود التخطيطية عبر جميع المستويات الإدارية
·
العمل
على جعل المدير مبتكرا وخلاقا إضافة إلى مبادرته في صناعة الإحداث وليس تلقيها
·
العمل
على توضيح صورة المؤسسة أمام كافة أصحاب الشأن والمصالح.[2]
المبحث الرابع: أهداف التخطيط الإستراتيجي
1. حتى لا تكون المؤسسة جزء من خطط الآخرين:
الهدف الأول هو أن لا تكون المؤسسة جزء من خطط الآخرين
لأنه إذا لم يتم التخطيط لمشروعك بشكل واضح و محدد ستكون جزء من خطط الآخرين وبالتالي
إذا لم تخطط لنفسك سيخطط لك الآخرون لان التأخير في عملية التخطيط سيحمل مخاطر كبيرة
وبالتالي فوات الأوان سيكلف الكثير ماديا ومعنويا.
2. الاستغلال الأمثل للموارد:
غالبا لا ترى المؤسسة بشكل واضح ما لديها من إمكانات مادية
وبشرية ولا يمكن أن تكتشف الطاقات التي تتميز بها عن غيرها فهي تستخدمها بعضا من طاقتها
وتمهل الكثير فالتخطيط الإستراتيجي هو إعادة اكتشاف المؤسسة وذلك من خلال معرفة مهارات
وقدرات العناصر البشرية؛ وتحديد رأسمال الفكري فيها والعمل على توظيفه التوظيف السليم
فجميع من يعملون بالمشروع هم رأسمال بشري كما إن داخل كل مؤسسة هناك رأسمال فكري وهو
العناصر المحدودة والمميزة التي تستطيع النهوض بالمشروع وتحقيق أهدافه؛ من ناحية أخرى
وباختصار يسعى التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المادية المتاحة
بالمؤسسة.
3. توحيد الجهود:
كل المشاريع لديها خطط وتعمل بكفاءة عالية ولكن الفرق بين
هذه الخطط؛ والتخطيط الإستراتيجي هو توحيد الجهود داخل المؤسسة بما يعظم الأداء ولتوضيح
هذه الجزئية يمكن تشبيهها بشعار الليزر فهو يستمد قوته وتأثيره من تجميعه وتركيزه في
اتجاه واحد وبالتالي لا يمكن تحقيقه إلا بتوحيد الجهود.
4. التفكير خارج الصندوق:
دائماً نحن بعيدا عن التخطيط الإستراتيجي نفكر بالشكل التقليدي؛
ولكن التخطيط الإستراتيجي القائم على الأساس العلمي يعتمد على التفكير الاستراتيجي؛
وهو أحد أشكال التفكير الإبداعي الذي يجعلنا ننظر إلى الأشياء بطريقة غير مألوفة ؛فالتفكير
الإستراتيجي هو الأساس في التخطيط الإستراتيجي.
5. وجود خطة عمل واضحة:
التخطيط الإستراتيجي يركز على وجود خطة عمل واضحة ومحدودة
لتنفيذ الأهداف أي خطة العمل هي الخطوات اللازم إتباعها لتنفيذ هدف معيّن.
6. التخطيط الإستراتيجي يجعلك تبدأ وعينك على
النهاية:
يقصد بها أن يكون لديك فهم واضح لما تريده ؛يقول ستيفن
كوفي في كتابه العادات السبع: أن أي شيء نجده أو نبدعه يتكون مرتين؛ الأولى التكوين
الذهني والتكوين المادي.[3]
المبحث الخامس: مراحل إعداد التخطيط الإستراتيجي
1. مرحلة بناء الإستراتيجية:
·
تحديد
الرؤية وصياغتها.
·
تشكيل
الرسالة- تحديد المهمة.
·
استعراض
القيم.
·
وضع
الأهداف.
·
صياغة
الإستراتيجية.
·
دراسة
وتحليل البيئة العامة والخاصة، تحليل الفجوات.
2. مرحلة بناء الإستراتيجية:
·
أدوات
التنفيذ.
·
إعداد
الخطة العملية وتوحيدها.
·
النموذج
الإطار العام
·
جدول
خطة إستراتيجية.
·
أمثلة
عملية لنماذج خطط.
·
إعداد
خطط بديلة.
·
تنفيذ
الخطط.
3.
مرحلة
الرقابة والتقييم:
1-
تحديد
الرؤية: تعتبر عملية تحديد الرؤية من أهم خطوات التخطيط الاستراتيجي الحديث. يقوم المخططون
في فريق التخطيط وقد يشاركهم مستشار أو أكثر بمحاولة تحديد هذه الصورة الذهنية بوضوح
وذلك من خلال مجموعة من الجلسات الهامة.
2-
تشكيل
الرسالة -تحديد المهمة-.
3-
استعراض
القيم و المبادئ.
4-
وضع
الأهداف.
5-
دراسة
و تحليل البيئة العامة و الخاصة و الداخلية.
6-
تقييم
الأداء-دراسة الواقع-.
7-
تحليل
الفجوات.
4.
مرحلة
تنفيذ الإستراتيجية:
وتدخل فيها أدوات التنفيذ،
الميزانية التقديرية ،خطط العمل التشغيلية.[4]
المبحث السادس: فوائد التخطيط الإستراتيجي
يساهم في توحيد القيادة والعاملين
نحو تحقيق الأهداف المعلنة والواضحة التي تؤدي الوصول إلى تطلعات المنشأة والمساهمين.
·
يعمل
على تجنيب المنشأة بتعزيز عوامل الخطر والاستعداد لها وتطويع الفرص والاستفادة منها.
·
يساعد
على تقوية البناء الداخلي للمنشأة بتعزيز عوامل القوة ومعالجة نقاط الضعف.
·
يشجع
الإدارة العليا والعاملين على الابتكار والإبداع وإيجاد الوسائل لتحقيق الأهداف المنشودة.
·
يساعد
على التنبؤ بالمتغيرات والظروف المستقبلية والاستعداد المسبق بالخطط البديلة.[5]
الفصل الثاني: تحديد الرزنامة
المبحث الأول: مفهوم الرزنامة
هي إستراتيجية تعتمد على
اختيار الوقت المناسب لإذاعة بيان سياسي أو قرار اقتصادي أو اتخاذ إجراء ما لكسب تأييد
الجمهور أو لتجنب مشكلة متوقعة وكثيرا ما نلاحظ إعلان بعض القرارات التي تستهدف إرضاء
المواطنين في مناسبات الأعياد أو افتتاح المشروعات الجديدة في ذكرى حدث قومي بارز.
ومن الضروري في جميع الأحوال
دراسة كافة الظروف المحيطة بالموقف والأطراف المختلفة المؤثرة عليه والمتأثرة به ثم
اختيار الوقت المناسب للإقدام على أي عمل يتعلق بهذا الموقف، وتظهر أهمية هذه الإستراتيجية
على مستوى المنظمات في تقديم المنتجات الجديدة أو اتخاذ القرارات الخاصة لرفع أسعار
سلع هذه المنظمات.
والرزنامة هي النشاط الهادف من قبل القيادة العليا في الدولة
والمجتمع (المنشأة) من أجل تجسيد القرارات الإستراتيجية بالشكل المفصّل وحسب أولويات
وإمكانيات تنفيذ هذه القرارات على أساس المعطيات الأولية المحددة التي تعكس
الحالة الجغرافية السياسية والإستراتيجية والاقتصادية ودرجة تحضير البني التحتية للدولة (المنشأة) وطبيعة
المواقف السياسية المحلية والدولية.
ينتج عن الرزنامة إعداد الخطط الإسرتارتيجية والتي تتألف
من عدد من الخطط تتمثل في
مجموعة من الوثائق النصية والترسيمية تعبّر عن مجموعة الأنشطة
والعمليات المتتالية واللازمة لتحقيق الأهداف الإستارتيجية وتسفر عملية التخطيط
عن ثلاثة أنواع من الخطط. [6]
المبحث الثاني: الجدولة
الزمنية للرزنامة
وهناك العديد من العوامل
التي تؤثر على اختيار الوقت المناسب للحملة الاتصالية أو نشر أي معلومات تتعلق بالمنظمة
و منتجاتها.
1. الجدولة الزمنية:
الجدولة الزمنية هي ترتيب
لأولويات تنفيذ عمليات معينة عبر فترة زمنية لإنجاز مهمة أو مهام محددة مع تحديد أزمنة
الأداء وتوقيت البدء والانتهاء العمليات في مراحل ومواضع الأداء المختلفة وترتيب تنفيذ
العمليات من حيث التوالي والتوازي وتخصيص الوقت.
وهي وضع الرسائل في جداول
زمنية ورسم البرنامج التنفيذي للإعلانات التي ستعرض خلال الفترة التي سيتم تحديدها
من أجل تقديم الرزنامة من خلالها. وتحدد جدولة الرزنامة وفقا لعدة عوامل تتمثل في موضوع
الرزنامة ومدى إدراك الجمهور له وما الهدف من هذه الرزنامة وكذا كافة الموارد المتاحة
لها.
2. مدة استمرار الرزنامة:
ليس هناك فترة محددة للرزنمة
فهناك رزنامات تستغرق أسبوع وأخرى أشهر وأخرى لأكثر من ذلك وإنما تجد مدة الرزنامة
حسب حجم الموضوع وأهميته وطبيعة الجمهور والهدف المراد الوصول إليه وأيضا حسب الموارد
المخصصة للإستراتيجية الاتصال.
3. أشكال الجدولة الزمنية:
-
الوقت
المتفائل : A وهو اقل وقت ممكن لتنفيذ الخطة
و إذا كانت الأمور تسير سيرا طبيعيا.
-
الوقت
المتشائم لB
: وهو أقصى وقت تستغرقه الخطة بفرض أن ظروف العمل غير مواتية غير أن هذا التوقيت لا
يتضمن احتساب الكوارث
-
الوقت
الأكثر احتمالا: C ويتم تقديره على ضوء الظروف العادية والخبرة المستخلصة
من الحالات المماثلة السابقة.[7]
المبحث الثالث: أهداف رزنامة الاتصال
1. الأهداف السلوكية:
ترمي هذه الأهداف إلى تغير سلوك الناس ونتائج سلوكهم على سبيل المثال قد تضع مجموعة
تعني بتحسين الأحياء السكنية هدفا يقضي بزيادة كمية التصليحات المنزلية الحاصلة. وعدد
المساكن المحسنة.
2. الأهداف على مستوى المجتمع المحلي غالبا ما
تأتي هذه الأهداف كنتاج أو نتيجة لتغير السلوك لدى الكثير من الناس، وهي تركز أكثر
على المستوى المجتمعي بدلا من المستوى الفردي.
3. الأهداف العملية:
أنها الأهداف التي توفر الأساس أو التطبيق الضروري لتحقيق الأهداف الأخرى.
المبحث الرابع: معايير تحديد الرزنامة
ومن الأمور التي يجب أخذها
في الحسبان عند إعداد هذه الرزنامة نجد:
إن إعداد رزنامة اتصال يهدف
إلى:
إظهار موعد استحقاق نشاطات
الاتصال وموعد انتهاء مهمة قائد المشروع
ينمي مرئيات كل نشاطات الاتصال
تدعم التنسيق داخل النشاطات
1.
المتطلبات
الداخلية:
في الوقت الأقصى للنشاطات
توفر المصدرين للرسائل، وتوفر قنوات بثها والمستقبلين لها، والتماسك بين مختلف الدعامات
الداخلية "الأحداث الداخلية"
2.
المتطلبات
الخارجية:
وهي متعلقة بالمتطلبات التقنية
وفترات الإدراك أو الفهم، التحقيق الفعلي، البث.
3.
المتطلبات
الحالية:
ما تتطلبه حملات الاتصال
الخارجي، الوضع الحالي لقطاع النشاط، نتائج المنظمة، والجو الاجتماعي الداخلي.
المبحث الخامس: أنواع الرزنامة
1.
الرزنامة قصيرة الأجل:
وهي
لا تزيد عن سنتين في أطول الحالات وغالبا ما تكون الفترة المحددة بسنة واحدة فقط
أو أقل، وهذا النوع من الرزنامات يتعلق بمستقبل القريب كما يهدف وضعها من أجل
تنظيم اتصال موجه للأزمات الطارئة التي قد تستمر لمدة قصيرة.
2.
الرزنامة متوسطة الأجل:
هي
رزنامة تتراوح في معظم الأحيان من 3 إلى 5 سنوات أما المدى المألوف لمثل هذا النوع
من الرزنامات هو 5 سنوات.[8]
3.
الرزنامة طويلة الأجل:
يتم
وضع مثل هذا النوع من الرزنامات لفترة زمنية طويلة المدى وعادة تستغرق أكثر من 5
سنوات إلى 20 سنة مقبلة حيث أنه كلما طالت المدة الزمنية لإستراتيجية الاتصالية
كلما زادت صعوبة وضع الرزنامة المنسبة.
المبحث السادس: تنفيذ الرزنامة وفق الإستراتيجية:
بعد اكتمال صياغة الإستراتيجية
يتجه اهتمام الإدارة العليا بعملية التنفيذ وإمكانية تفاعلها واتساقها مع الإستراتيجية
الموضوعة، وتعتبر مرحلة التنفيذ من أهم مراحل الإدارة الإستراتيجية حيث إن التنفيذ
غير الفعال للخطط والسياسات يؤدي إلى الفشل، بينما التنفيذ الصحيح والفعال يؤدي إلى
التعويض عن التخطيط غير المناسب الدوري، فمن خلال هذه المرحلة يجب أن تتحول إستراتيجية
المنظمة إلى أفعال ملموسة ذات نتائج لها دلالتها وإلا انتهت جميع الأنشطة المكونة للإستراتيجية
الإدارية دون جدوى للمنظمة ، ولإنجاز ذلك لابد من تحديد الأهداف السنوية ، وضع البرامج
الزمنية، وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق الإستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات
التنفيذية. وفيما يلي توضيح موجز لهذه الخطوات:
1.
تحديد الأهداف السنوية :
يتم تحديدها بطريقة لا مركزية،
إذ ترتبط بصورة مباشرة بكل مدير من مديري قطاعات وإدارات وأقسام المنظمة. وبناءً على
هذه الأهداف يتم توزيع وتخصيص الموارد ، حيث أنها تحدد الأولويات الخاصة بالأفراد والإدارات
والأقسام، وتمثل المحدد الرئيس لمدى التقدم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلا أن
ذلك يتطلب التنسيق بين الأهداف السنوية والأهداف الإستراتيجية
2.
وضع البرامج الزمنية:
تتضمن هذه البرامج الأهداف السنوية
التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها في ضوء الخطة الإستراتيجية، والموارد اللازمة لها، والأنشطة
الواجب القيام بها والزمن الذي يجب البدء والانتهاء فيه من هذه الأنشطة ، والمسئولون
عن تنفيذها.[9]
3.
تخصيص الموارد اللازمة:
من المهم التأكيد على أن تنفيذ
الإستراتيجية لا يقتصر على استغلال موارد المنظمة فحسب بل على حمايتها وتنظيمها وتوجيه
استخدامها ، وكيفية توزيعها على البرامج والمشاريع باعتبارها نظماً جزئية تعمل على
المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية. فلا بد من تصنيف الموارد ؛ لمعرفة القدرة التنظيمية
والممهدة لتنفيذ الإستراتيجية حيث إن التنفيذ يتأثر بالموارد المتوفرة والقدرات المتاحة
الفعلية والاحتمالية للمنظمة.[10]
4.
تحديد الإجراءات التنفيذية :
حيث تمثل الإجراءات " نظام
يتكون من خطوات متتابعة تحدد طريقة أداء مهمة أو وظيفة معينة وتصف بالتفصيل الأنشطة
المختلفة التي يجب أدائها لإنجاز برامج المنظمة.
أي أن وضع الاستراتيجيات موضع
التنفيذ يتطلب توفر العناصر التالية :
- وجود هيكل تنظيمي
ملائم بناء هيكل جديد ، تدريب ، توفير الموارد البشرية ، تعديل الهيكل الحالي.
- ملائمة الاستراتيجيات
للسياسات الحالية أو تعديل السياسات التي تتعارض مع الاستراتيجيات الموضوعة.
- وضوح في مسؤوليات
الإدارات عن تنفيذ الإستراتيجية[11]
الخاتمة:
ومن خلال ما سبق نستنتج أن في
أي مؤسسة مهما كان طابعها العملي تجاري أو صناعي أو خدماتي فهي تحتاج إلى مخطط
عملي ديناميكي, تسمو من خلاله إلى تحقيق أهدافها وهو ما يعرف بالإستراتيجية ولن يتسنى ذلك إلا بوضع منظومة اتصالية تعتمد على وسائل
ودعامات مناسبة لنقل رسائلها إما على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي ولذلك
عليها مراعاة مجموعة من العوامل المهمة كإمكانيات المؤسسة المادية والرسالة التي
تريد توصيلها والجمهور الذي تريد تبليغه الرسالة التسويقية وفق رزنامة اتصالية
تكون موزونة وفق الإستراتيجية وتوافق لها من أجل تنظيم الاتصال وضمان حسن سير
العملية الاتصالية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لضمان تحقيق إستراتيجية
اتصالية ناجحة ومتوازنة تحقق أهدافها الموضوعة.
[1] ناصر دادي عدون:الاتصال و دوره في كفاءة المؤسسة
الاقتصادية،د ط ، الجزائر 2004 ، ص81.
[2] محمد البادي: التخطيط الاستراتيجي للاتصال ، مصر
، دار المهندس للطباعة ، ط1 ، 2005 ، ص104-106.
[3] محمد البادي: مرج سبق ذكره ، ص 117.
[4] محمد البادي: مرج سبق ذكره ، ص 125.
[5] محمد البادي: مرج سبق ذكره ، ص 141.
[6] سكودارلي حياة
وظريف نورة: الاتصال ودوره في ترشيد قرارات المؤسسة (دراسة حالة المخبر الصيدلاني
الجزائري LPN)،
مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة الأعمال الاستراتيجية، المركز الجامعي
العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة الجزائر، 2011-2012، ص20.
[7] سكودارلي حياة
وظريف نورة: مرجع سبق ذكره، ص 45.
[8] فؤادة عبد المنعم البكري: التسويق الاجتماعي وتخطيط الحملات
الإعلامية، عالم الكتاب، القاهرة، 2007 ، ص106-108
[9] فؤادة عبد المنعم البكريمرجع سبق ذكره ، ص 109.
[10] فؤادة عبد المنعم البكريمرجع سبق ذكره ، ص 110.
[11] شريط
حورية: مكانة الاتصال الداخلي في المؤسسة العمومية الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، الجزائر
: كلية الآداب و اللغات ، قسمالإعلام والاتصال، 2000، ص 159.

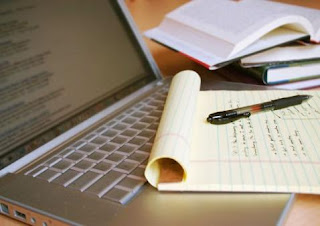

تعليقات: 0
إرسال تعليق